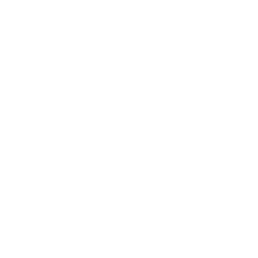لعل الكثير من الناس قد شعروا بهول الصدمة مما يحدث في بعض الدول الغربية بخصوص أحداث فسليطن.
القفز إلى الخلف
كيف لا يشعرون بهذه الصدمة وهم يتابعون مواقف وممارسات بلدان “التنوير” و”الديمقراطية” و”حقوق الإنسان”…؟ فهذا وزير خارجية أمريكا (التي قال عنها دي تكوفيل أنها حكومة أكثر علمانية بينما شعبها أكثر تدينا) يقول: لقد جئت إليكم (مخاطبا الإسرائيليين) لا بصفتي وزيرا أمريكيا وحسب، وإنما بصفتي يهوديا! وتلك حكومة فرنسية تمنع التظاهر المندد بالمجازر الإسرائلية في حق الفلسطينيين، وتحرمهم من حقهم في التعبير عن آرائهم، وتتعهدهم بالسجن والغرامات بداعي “الحفاظ عن النظام العام”،
وهنالك حكومة ألمانية تحدد للمظاهرين الخطوط الحمر التي لايمكنهم تجاوزها وتعتقل كل من يحمل راية فسطين أو يهتف بشعار”فسلطين حرة”، وذاك نادي رياضي يراقب ما يخطه لاعبوه في مواقع التواصل الاجتماعي، ويخيرهم بين الحذف والاعتذار أو الطرد، وتلك صحيفة بريطانية عريقة تخبر رسامها الكاريكاتوري المشهور بأنه لم يعد مرغوبا فيه مباشرة بعد انتهاء عقده؛ لأنه تجرأ على رسم رئيس حكومة إسرائيل في وضعية دموية، وتلك قناة إعلامية لطالما انتقدت الإضرار بالحريات الصحفية في البلدان غير الديمقراطية، بينما هي اليوم تحقق مع صحفييها بدعوى التعاطف مع أطفال فلسطين… نعم كيف لا يشعر الإنسان، كل إنسان، بهذا الكيل بمكيالين، وهذا القفز إلى الخلف، وهذا التخبط والتناقض؟ ألا يدفع هذا الوضع بالناس إلى اليأس من كل أفكار هذا الغرب الذي يدعي العلمانية والحرية وحقوق الإنسان؟
نعم، من حق الإنسانية أن تمقت هذه التصرفات، وأن تستهجن ممارسات الحكومات الغربية القمعية، وأن تعود إلى الذات وإلى التموقع داخل الهويات الخاصة، ويحق لها أيضا أن تتمترس بحيثياتها الوطنية عندما ترى الآخرين يجمعون على وسمهم بالتخلف والعنف، ويرمونهم بأشد النعوت إيلاما.
غير أن بصيصا من الأمل يعلو في الأفق، وأن ضوءا خافتا يظهر في آخر النفق المظلم، وهو ما يساعد على القول بأن الغرب العلماني هو مريض جدا، بل لم يشف من مرضه القديم المتثمل في الرؤية الاستعمارية للشرق؛ فعلى الرغم من أن الأصوات التي تعبر عن هذا المرض هي التي تتسيد المشهد اليوم، إلا أن ما يبعث على الأمل أن هناك ما يعكر صفاء سمائها.
غرب آخر
ومن ثم، فإن غربا آخر أكثر علمانية بل غربا يتبنى العلمانية الصلبة، يحاول جاهدا أن ينتصر للقيم الانسانية، وأن يساعد النفس الانسانية على تذكر عالم مُثُلِها حسب التعبير السقراطي، ومن هنا جاز وسْم الأمر على نحو “غرب ضد غرب”، وأما مظاهر هذه الضدية، فيمكن تلمسها في الآتي:
– صحيح أن الآلة الإعلامية الغربية منخرطة في البربوغاندا الصهيونية، ولا رواية ترويها غير الرواية الإسرائلية، لكن هذا لا يمنع من تسرب الرواية الفلسطينية إلى الإعلام الغربي نفسه، سواء في نسخته الموجهة للعرب بالعربية أو في نسخته الموجهة للعالم بمختلف اللغات، لأن شمس الحقيقة لا يمكن حجبها، كما لا يمكن للصوت الواحد والرواية الواحدة أن تكون محفزة على المتابعة. الأمر الذي استدعي إشراك أصوات أخرى، وعلى سبيل رفع الحرج، من مثل مصطفى البرغوثي وزملط وباسم يوسف وغيرهم.
– وإذا كانت الرقابة قد ضُربت على كل الوسائط التي تشكل الرأي العام الغربي من خلال حجب معلومة معينة، وضخ معلومة أخرى، وطمس راوية في مقابل صناعة رواية زائفة تحت شعار”اكذب حتى يصدق الناس”، فإن هذا الغرب المالك للتكنولوجيا لم يصد جميع الأبواب في وجه طالبي الحقيقة؛ فمحرك البحث “غوغل” ما زال مستمرا في توفير كل المعلومات، و”اليوتوب” مستمر في ضخ كم هائل من المعلومات والمقاطع التي تنشر الرواية المعاكسة، كما أن هناك نزر ولو يسير من الأعمال السينمائية التي تهدف إلى الموضوعية.
– وبينما يروم البعض أن يأخذ الصراع طابعا دينيا مثلما فعل وزير خارجية أمريكيا، أو مثلما يفعل الكثير من أعضاء البرلمانات في فرنسا وألمانيا وأمريكا، فإن طيفا سياسيا آخر بدأ يجرؤ على الحديث، من قبيل العديد من الوزارء في اسبانيا وكندا وإيرلندا والنرويج وبلجيكا وسكوتلندا، واستقالة مسؤولين في أمريكا، كما انقسم الطيف السياسي الفرنسي على نفسه بخصوص القضية الفسلطينية، حيث ما زال حزب “فرنسا الأبية” بقيادة”ميلنشون” يواجِه انتقادات كثيرة من قبل أحزاب اليمين بمعتدليها ومتطرفيها لأنه يرفض إدانة الفلسطينين. ونفس الأمر بالنسبة للمجتمع المدني العالمي الذي هرع جزء منه لتقدم المساعدات للفلسطينيين، بنيما ساهم البعض الآخر في تكثير سواد المظاهرات المناهضة لما تقوم به “إسرائيل”، وذلك في كل الدول الأوروبية، وبصرف النظر عن مضمون الشعارات التي ترفع ونوع الرموز التي ترفع وتحرق، بل حتى في ألمانيا وفرنسا خرجت مظاهرات كبيرة ولم يقتصر الحضور فيها على المسلمين والعرب وإنما شاركهم في ذلك مواطنون أوروبيون منهم الملحدون ومنهم المدافعون التقليديون عن المناخ وعن المثلية الجسنية وعن حقوق الناس وعن حقوق الأقليات. وأما في أمريكا التي يسطير اللوبي الصهيوني على حكومتها، والذي يضرب له الساسة ألف حساب، ويهابونه أكثر من خشيتهم الرأي العام، فإن التظاهرات كانت أكثر قوة وأكثر شساعة، ولم يتجرأ أي سياسي أو إعلامي على أن يدعو إلى حظرها أو حظر بعض شعاراتها لأن التعديل الأول للدستور فوق كل اعتبار (يمكن مراجعة الموسوعة الحقوقية التي تضم آلاف القضايا التي انتصر فيها أصحابها بناء على هذا التعديل)، بل إن الشكل الاحتجاجي الذي آلَمَ الحركة الصهونية كثيرا فهو ذلك الذي جسده اليهود الذين اقتحموا (نعم اقتحموا) باحة الكونجرس الأمريكي، وهتفوا بأصوات عالية “ليس باسمنا” داعين إلى وقف الحرب على غزة، متهمين الحكومة الإسرئيلية بممارسة كل أشكال العنف، بينما يعتبر الكثير من يهود العالم وجود إسرئيل خطئية دينية. فضلا على أن آخر استطلاعات الرأي قد آظهرت أن نسبة تفوق النصف من المواطنين الأمريكيين ترفض تزويد الحكومة الأمريكية لإسرائيل بالأسلحة، وينظرون إلى الدعم الأمريكي بأنه مبالغ فيه.
– ولئن منعت بعض النوادي الرياضية الأوربية لاعبيها من التعبير عن تعاطفهم مع الفلسطينين، فإن نوادي أخرى، رفضت سلك هذا التوجه، ونظيرُ ذلك ما قام به فريق كرة القدم “فريدر بريمن” الألماني عندما رفض إصادر أي توجيهات للاعبيه بخصوص ما يحدث في فسلطين، وأما جمهور نادي “سلتيك” السكوتلندي فهو لم يكتف بالإدانة الفردية، وإنما اتخذ تعاطفه مع الفلسطينيين شكلا جماعيا يكاد يكون ثابثا منذ سنوات، وبنفس الطريقة عبر جمهور نادي “أوساسونا” الإسباني وبعض جمهور “ليفربول” الإنجليزي، ونفس الأمر بالنسبة لجماهير “ريال مدريد” وغيرها من الجماهير التي تحدت توجيهات أنديتها وخالفت أوامر الحكومات التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني.
– قد يكون مسلما به أن الأوساط السينمائية تكاد تكون مجمعة على جهلها بحقيقة الصراع الفلسطيني، وذلك نتيجة حتمية لدورانها في فلك عالم المال المسيطَر عليه من قِبل اللوبي الصهيوني، لكن هذه السيطرة ليست مطلقة، وإنما هناك اختراقات لا بأس بها تحققت لصالح الفلسطينيين، وهو ما تجسد في مواقف الكثير من الممثلين الذين ساعدهم اطلاعهم على تفهم الحق الفلسطيني أمثال مارك روفالو وسوزان ساراندو وجون كوزاك ووليام كاننغهام وميل جيبسون وغيرهم من الممثلين المنتصرين للقضايا الإنسانية العادلة.
– وإذا كانت الغالبية الظاهرة في عالم السينما قد تبدو مؤيد لإسرائيل، فإن الغالبية من المثقفين والمفكرين المشتغلين في مجال حقوق الانسان والهتمين بالقضايا الدولية، تكاد تكون شبه مجمعة على إدانة ما تقوم به إسرائيل في حق الفلسطينيين، وهذا حال العديد من أساتذة الجامعات العريقة واتحادات طلابها (يمكن مراجعة بلاغات طلبة وأساتذة جامعة هارفرد على سبيل المثال)، لأن العلم لا يمكنه أن يوافق على وجود الاستعمار، أو أن يؤيد إحلال شعوب مكان أخرى بناء على تصورات دينية تنهل من الماضي وتتأسس عليه.
عموما، يمكن القول إن الغرب ليس واحدا وإنما هناك غرب متعدد، وقد يبرز غرب معين اليوم، وقد يخفت الغرب الآخر تحت ضغط اللوبيات التي تؤثر على الساسة بسبب مصالحهم الشخصية وليس انتصارا للقيم التي تأسست عليها دولهم، لكن كما لا يمكن للظلم أن يستمر، فإن الغرب المنتصر للظلم لا يمكنه إلا أن يخفت أو يزول. بينما وارد جدا أن تنتصر الأصوات المؤيدة للحقوق والمدافعة عن القيم الإنسانية المشتركة، والرافضة للكيانات المتأسسة على نظريات دينية بصرف النظر عن لونها وأشكالها ومضامينها.
لذلك،من المتعجل جدا الحكم على الغرب بأكمله جملة وتفصيلا، واتهامه بمعاداة العرب والمسلمين والتنكر لقيمه في مجال حقوق الإنسان، وإلا فإن من شأن هذا التعميم أن يجعل الجميع في بوثقة واحدة دون تمييز، وهو الأمر ذاته الذي يؤاخذ عليه الغرب عندما يجعل الجميع في كفة واحدة، ويضع جميع المسلمين، مثلا، في حالة شبهةٍ دائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال لم يتناول إلا جانبا ما أصبح ينعت بـ “الغرب”، وإلا فإن جل دول العالم وشعوبها، تنتصر للحق الفلسطيني، وتدين الاحتلال الإسرائيلي، وتندد باستخفافه بالمواثيق الدولية والقرارات الأممية الصادرة لصالح الفلسطينيين، مثل ما تقوم به دول آسيا وأمريكا اللاتينية ودول إفريقيا (مثل المواقف الأخيرة لكل من جنوب إفريقيا وكولومبيا ..).