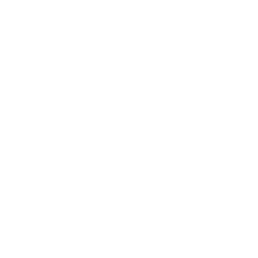في زمنٍ تتقاطع فيه المواقف، وتتبدّل فيه المبادئ كما تتقلّب الفصول، يصبح استحضار بعض القصص التراثية ضرورةً لا ترفًا، لأنها تختصر واقعنا الحالي بمرآة صافية لا مجاملة فيها، وذلك لما تحمله من دلالات عميقة.
ومن هذه القصص حكاية الأمير بشير الشهابي مع خادمه، والتي تحوّلت إلى ما يشبه “نظرية اجتماعية” تختزل سلوك شريحة واسعة من الناس، أُطلق عليها “نظرية وثقافة الباذنجان”.
اذ يحكى أن الأمير قال لخادمه يومًا إنه يشتهي الباذنجان، فراح الخادم يمدح هذه الخضرة ويستفيض في تعداد مزاياها قائلًا: “إنه سيّد المأكولات، لحمٌ بلا شحم، وسمكٌ بلا حسك، يُؤكل مقليًّا، ويُؤكل مشويًّا، ويُؤكل محشيًّا، ويُؤكل مُخلَّلًا، ويُؤكل مكدوسًا.”وبعد برهة قال الأمير إنه عانى ألمًا في معدته آخر مرة تناوله فيها، فما كان من الخادم إلا أن غيّر موقفه بسرعة، ولعن الباذنجان وعدّد مساوئه قائلاً: “إنه ثقيل، غليظ، نَفّاخ، أسود الوجه!” وكأنه لم يمدحه قبل لحظات. ولما استغرب الأمير هذا التناقض السريع، أجابه الخادم: “يا مولاي، أنا خادمٌ للأمير ولستُ خادمًا للباذنجان. إذا قال مولاي نعم قلتُ نعم، وإذا قال لا قلتُ لا!”
والحقيقة أن هذه القصة ليست طرفة بقدر ما هي توصيف صادق لحال كثير من الأشخاص “الباذنجانيين” الذين انتشروا وبشكل لافت في مجتمعاتنا؛ أولئك الذين يغيّرون جلودهم تِبعًا لمصالحهم من دون اعتبار أو مصداقية، فيؤيّدون الفعل ونقيضه، ويرون في التقلّب مهارة، وفي النفاق شطارة، بينما يصبح صاحب المبدأ في نظرهم “مجنونًا” لأنه يضيّع فرص الريح التي تهبّ من كل اتجاه.
ويبلغ هذا السلوك ذروته في مواسم الحشد والاصطفاف، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات، حيث تُستبدَل المبادئ بمصالح عابرة، وتُباع القناعات مقابل وجبة أو وعد أو مكسب، إلا من رحم ربي.
وأعرف شخصيًّا أناسًا نبغوا في ركوب الموجة؛ فأراهم يفطرون مع قوم، ثم يتغدّون أو يتعشّون مع آخرين يناقضون من فطروا أو تغدّوا معهم! لكن خطورة هذه “الثقافة الباذنجانية” ـــ الدخيلة علينا عبر وسائل التواصل التافهة ـــ لا تكمن في كونها سلوكًا فرديًّا فحسب، بل في احتمال تحوّلها مع الوقت إلى ثقافة عامة قد تتسرّب إلى بيوتنا ومجالسنا، وتصبح معيارًا للتعامل والنجاح، مما يضرّ بالمجتمع، ويشوّه قيمه، ويجهض فرص تقدّمه، إذا لم نتصدّ لها بكل شجاعة وحزم. فشتّان بين الباذنجان كخضرة، وبين “نظرية” وعقلية الباذنجانيين.
وإذا كان المجتمع يعاني من أصحاب المواقف المتبدّلة، فإنه يعاني أيضًا من أزمة لا تقلّ خطرًا: أزمة ضياع الذكاء والأفكار فيما لا يفيد. وهذا ما تختصره حكاية أخرى في عهد هارون الرشيد، إذ جاءه رجل يفاخر بمهارته في رمي الإبر بحيث تدخل إحداها في ثقب الأخرى. أعجب الخليفة بحذقه وعبقرتيه، لكنه أمر بجلده مائة جلدة ومنحه مائة دينار. ولما سُئل عن هذا التناقض، قال قولته البليغة التي تستحق أن تُكتب بماء الذهب “أعطيته مائة دينار مكافأةً على حذقه وذكاءه، وجلدته مائة جلدة لأنه أضاع ذكاءه فيما لا يفيد.”
إن التشتّت، والعزلة النفسية، وضغوط الحياة، ومغريات الشهرة والربح السريع على وسائل التواصل، كلّها دفعت كثيرين إلى تغيير مبادئهم وإهدار قدراتهم في محتويات تافهة وأفكار فارغة ومشاريع لا تُغني ولا تُسمن من جوع، حتى صارت العبقرية تُصرف لقلب زجاجة، أو تقليد صوت، أو مطاردة “ترند”، أو تغيير المواقف بالكذب والافتراء، فضاعت الأفكار الجادة في ضجيج السطحية.
ومن هنا، فإن النقد الذاتي ـــ لا جلد الذات ـــ والابتعاد عن “نظرية الباذنجان”، ووقف هدر الأفكار، هو المفتاح الحقيقي للنهوض بالأفراد. فهو الذي يحرّر العقل من الأوهام، ويعيد ترتيب المسار، ويقطع الطريق على النفس الانهزامية. فالحضارات لا تسقط لأن أعداءها أقوياء فقط، بل لأنها تتوقف عن التفكير، وترفض التجديد، وتخشى النقد؛ كما حدث في الأندلس حين ضاعت روح النهضة وحلّ محلّها الجمود والصراع على التفاصيل التي لا تُغني ولا تُسمن.
وعليه، فإننا اليوم بأمسّ الحاجة إلى أشخاص ثابتين على مبادئهم، لا يمدحون اليوم ما يذمّونه غدًا، ولا يبيعون ذممهم عند أول مفترق، وكذلك نحن بحاجة إلى عقول تستثمر ذكاءها في البناء لا في العبث، وفي الإبداع لا في الاستعراض كما يحدث عبر مواقع التواصل التافهة اليوم.
لأنه لا نجاح بلا فشل، ولا تقدّم بلا تعثّر، ولا نهضة بلا نقد ذاتي واعٍ. أمّا الانصياع لموجة التلوّن أو الاستسلام لدوائر العبث واليأس، فهو الطريق الأقصر إلى مجتمع بلا ثوابت ولا منجزات.
ولهذا أرى أن “نظرية الباذنجان” ليست قصة طريفة ولا جزءًا من المطبخ، بقدر ما هي جزء من النفس حين تهجر المبادئ وتلوذ بالمنفعة. وهي تحذير من مجتمع يصفّق للرياء ويهمّش “ marginalizes “ أصحاب المبدأ. وفي المقابل، فإن حكاية الإبر ليست مظهرًا من مظاهر العبقرية، بل درس في أن الذكاء بلا هدف كالريح بلا اتجاه. وبين الحكايتين تظهر الحقيقة الصارخة: وهي إن المجتمعات لا بمكن أن تنهض بما تملك من ذكاء، بل بما تختار أن تفعل بهذا الذكاء… ولا تتقدم بما ترفع من شعارات، بل بما ترتكز عليه من مبادئ وقيم.
ولعلّ أجمل ما يمكن ان نختم به، هو أن الأمم لا يمكن ان ترتقي بما تملك من مواهب، بل بما تهتدي إليه من قيم… ولا تنهض بما تعرف من حِيَل، بل بما تحافظ عليه من ثوابت.