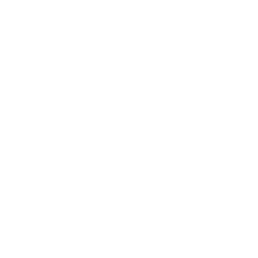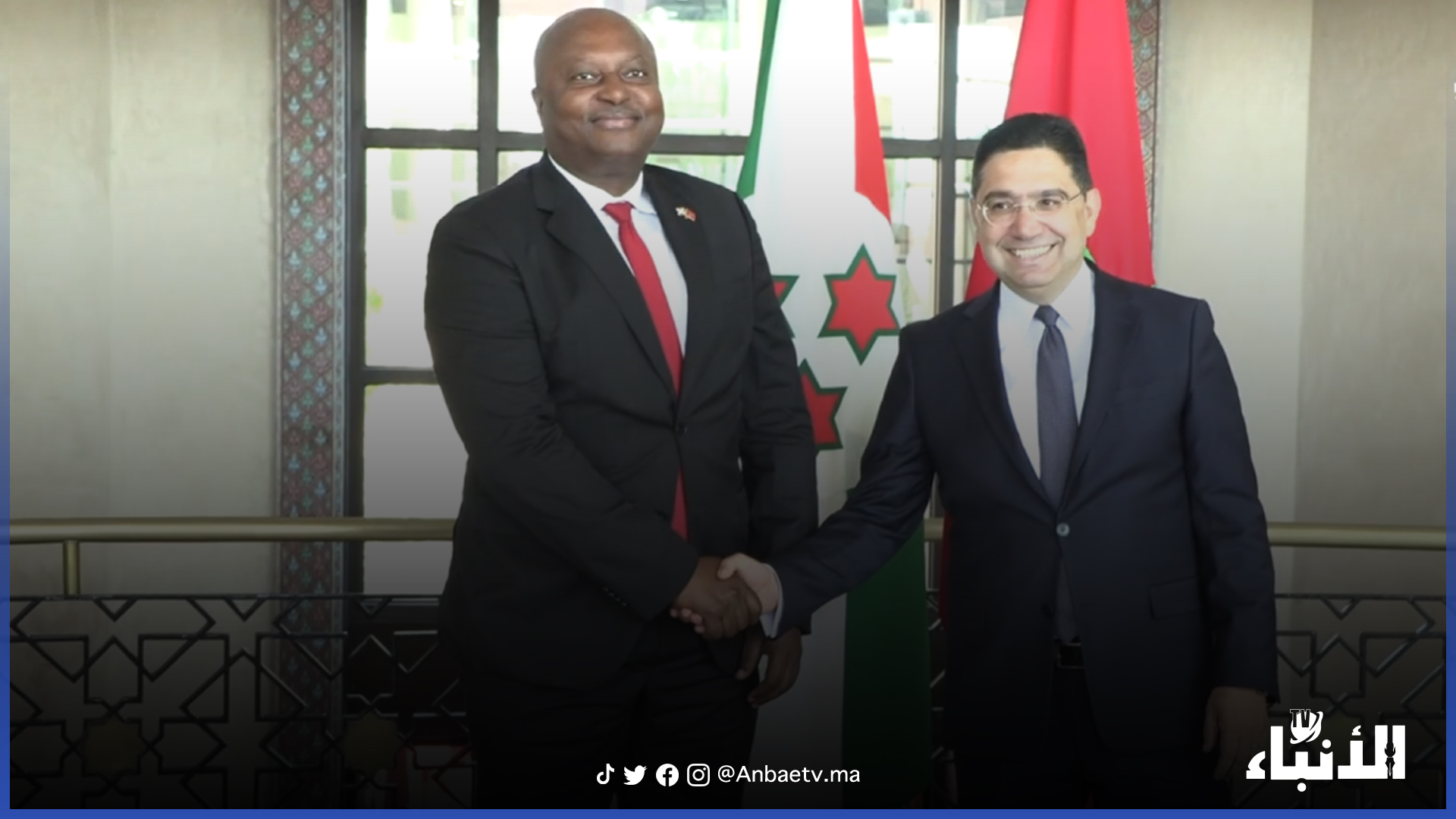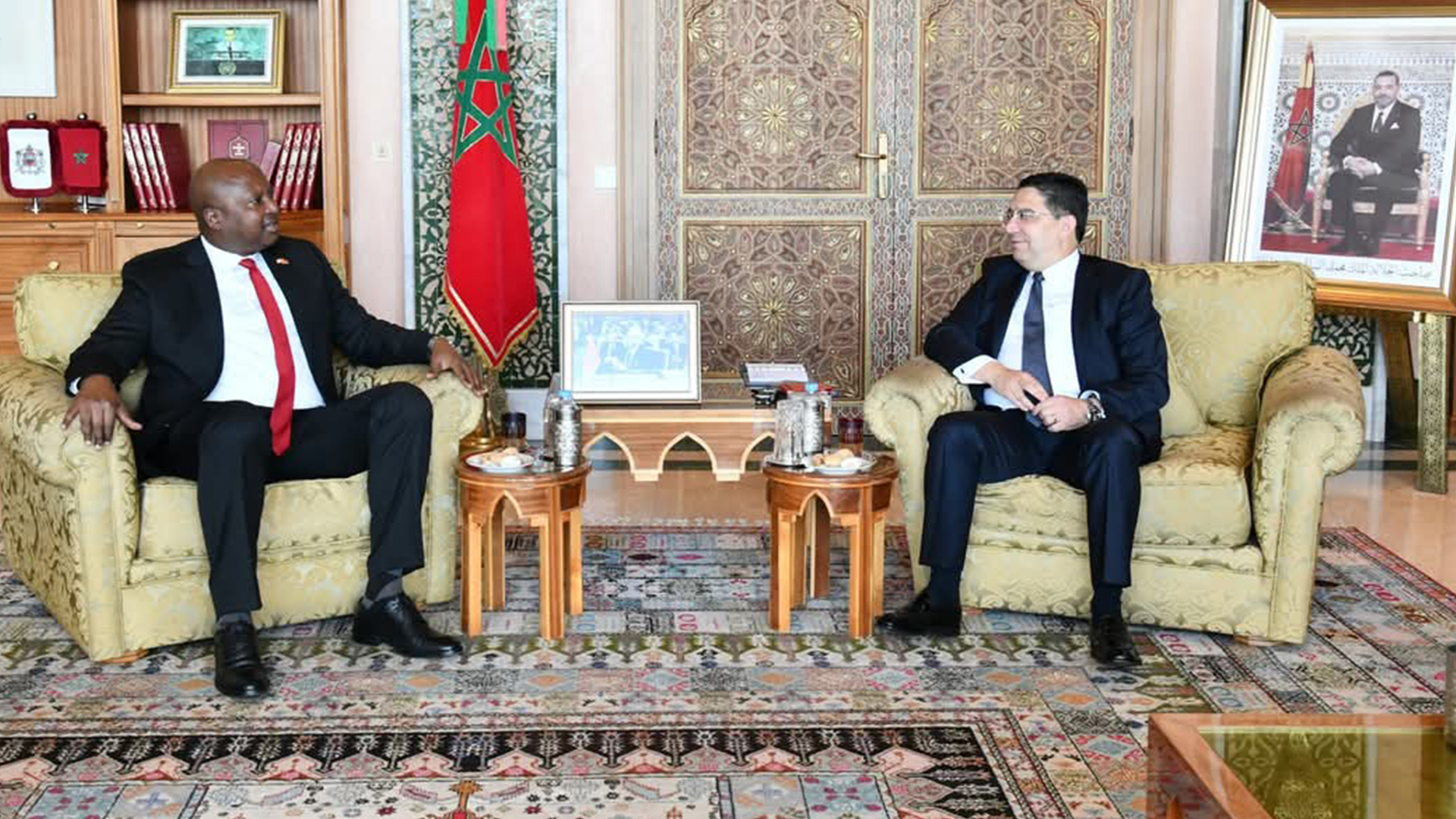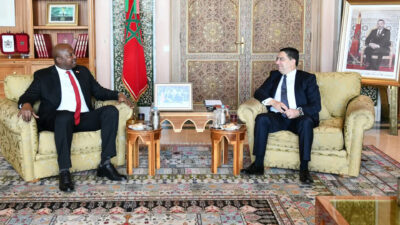الخوض بين تاريخنا، وقلب صفحاته وإعادة إنتاج بعض من خباياه، شيء قد يفرض علينا نفسه أحيانا، وربما قد نكون مجبرين على إعادة إحيائه أحيانا أخرى، أو المحافظة عليه حتى لا يندثر ويزول للأبد.
ولعل أهم جزء من هذا التاريخ، ما يتعلق بحياتنا اليومية كيف كانت؟ وكيف تغيرت من السلب نحو الإيجاب؟ وأحيانا كيف تغيرت من الإيجاب إلى السلب؟ وأسئلة أخرى كلها تدور في فلك تاريخنا ومدى تأثيره على ملامح واقعنا، أو بالأحرى تاريخنا المطموس بأشياء دخيلة علينا، كما هو حال نمطنا الاقتصادي، بين اليوم والأمس؛ مدخولنا اليومي كيف كان يجنيه ممن سبقنا من أجدادنا، وكيف صار اليوم داخل بيوتنا؟..
إن المتأمل والشاهد العيان لهذا الواقع وللتاريخ السابق، لَأكيد أنه سيلاحظ الفرق الجلي بين الاثنين، وسيكتشف كيف تحول نمطنا الاقتصادي من اليدوي إلى الآلة الطاغية، وسيستشف أهم ملامح التغيير التي طرأت على الكثير من حرفنا، منها ما تطور، ومنها ما أقبر ومنها ما لا يزال في صمت يُحتضر.
وحصائر الدوم من بين هذه الحرف التي لا زالت تحتضر، تقف صامدة الوجدان أمام طغيان حصائر البلاستيك، وزرابي الصين والترك، إنها حرفة رأسمالها مواهب وذكاء وعتاد بسيط، كلفت الإنسان المغربي شيئا من الصبر والعزيمة، ومنحته بديلا غير مكلف، للحصول على المال والاحترام، وأغنت البعض عن التجارة والفلاحة والأعمال الوظيفية. لكن تلك المهن والحرف لم تعد لها زبائن الأمس.
جولة قصيرة بسوق السمارين، تجعلك تستشف ذلك، وتلمس عن قرب واقع تلك المهن وحياة ممتهنيها الذين لم يتبقى منهم سوى اثنين فقط داخل السوق، وشرذمة من الصناع الموزعين بين أطراف إقليم الحوز بجهة مراكش أسفي.
حرفة يدوية تصارع طغيان الآلة
كثيرا ما تلتقي الثقافة بالطبيعة في الصناعة التقليدية، وبالخصوص في حرفة صناعة حصير الدوم، حيث يتم استخدام قوي للعناصر النباتية الخام كالسمار الذي يجمع، ثم يجفف حتى يصير جاهزا لصنع حصير سيفرش أرضية الغرف والمساجد..؛ حيث يستعمل المعلم صانع الحصير السمار أو كما هو متعارف عليه في عدد من المناطق الأمازيغية ب”أزماي” أو الدوم، كموروث تقليدي تداولته الساكنة المحلية في حياتها اليومية، والذي هو عبارة عن نبات قصبي ينتشر كثيرا في الأوساط الرطبة، أزهارها خضراء مائلة إلى البني، طويلة وكثيرة، في أعلى الساق تزهر ما بين شهر مايو ويوليوز وشهر غشت؛ وتنتشر بكثرة في بعض المناطق بإقليم الحوز، وبجهة ماسة بشكل كبير، حيث تبتدأ عملية صنع الحصير بتجميع أكبر عدد ممكن من هذه النبتة ليتم عرضها مباشرة تحت أشعة الشمس ليوم أو يومين كاملين، ليتم الاحتفاظ بها لتستعمل فيما بعد في عملية نسج الحصير.
حفظ السمار خلال ذلك، قد يستمر حتى إلى السنة دون أن يفقد أي شيء من قيمته الطبيعية، بل ربما قد يصير أكثر عمليا في عملية النسيج. وبذلك يصير ومن خلال هذا المفهوم السمار كمنتوج تقليدي قديم في المتخيل الجمعي له خصوصياته البيئية والثقافية، يخرج من وسط طبيعي بالأودية وجنبات المستنقعات إلى مداشر ريفية يزينها ويجلي البرد عن أصحابها، بل أبعد من ذلك، فقد كان يوفر قوتهم في زمان لم يكن فيه منتوج سواه يدرون منه دخلا، فالسكان في علاقتهم بهذا المنتوج يهتمون به ويحترمون أوقات حصده، ويدافعون عنه ويمنعون الرعي فيه، وقطعه وتخريبه، وما يلاحظ حاليا تشكل هذا الموروث في ثقافة الناس وارتباطهم به حيث يعتبر رمزا للبذخ عند البعض في المنازل والفنادق الفخمة ثم الرياضات كذلك.
بعد هذه العملية مباشرة، يتم تفعيل ذكاء الصانع التقليدي، والإفراج عن مهاراته التي اكتسبها عن أجداده، على الرغم من أن هذه العملية قد تختلف من منطقة إلى أخرى، وكذلك على حسب نوعها (أمازيغية/ عربية)، إلا أن أهم ما يميز هذه الحرفة، أنها تتم من قبل عاملين أو أربعة على الأكثر، حيث تتجاوز مدة صنع الحصيرة الواحدة حوالي العشر ساعات.
الدراز.. الآلة السحرية
خلال هذه العملية، يقوم المعلمين بإنجاز “الدراز” وهو المكان المخصص لصنع الحصير، ويكون على شكل مستطيل في كل زاوية به، توجد أعمدة صغيرة تكون قد دقت بالأرض خصيصا لهذا الغرض، والتي تسمى بالامازيغية “افكيكن”، توجد بينها ثقوب تمر منها خيوط الحصير المثبتة للسمار.
بعد نسج الحصير، يتم قفل جميع جوانبه حتى يصير جاهزا للاستعمال، إلا أنه وأحيانا قد يتطلب أن يوضع الحصير تحت أشعة الشمس مرة أخرى إلى ان يستوي، ومن أهم ما تتطلبه العملية أن لا تصل نقطة ماء إلى الحصير حتى يبقى محتفظا بجودته لأطول مدة ممكنة.
على بعد كيلومترات قليلة من مدينة مراكش، وباتجاه جماعة اكفاي، وبالضبط بدوار بوراس، حيث لا زال سي المختار يقاوم أزمة سوق حصائر الدوم رفقة ابنه الصغير، وينتظر فرجا ربما قد يأتي هذه السنة، وربما سنة أخرى، وربما قد لا يأتي، لكن الأساس أن لا يضيع يومه دون أن يمارس ما علّمه إياه أجداده، حتى ولو كان بدون مدخول، لأشهر ولسنوات، لكنه لا يمل أبدا.
حال المختار، مثل حال آخرين من صناع حصيرة الدوم، والذين ينقص عددهم من يوم إلى آخر، فبعد أن كان عددهم يتجاوز 200 عامل، بات اليوم عددهم لا يتجاوز رؤوس الأصابع العشرة،
إلى جانب ذلك، يواجه الرجلان المتواجدان على مستوى سوق السمارين مشاكل عديدة من حيث بيع كل ما أنتجوه طيلة السنوات الماضية، وخاصة بعد تراجع المواد الأولية والإقبال على هذا المنتوج، سواء من حيث الساكنة أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أوقفت وطيلة السنوات الأخيرة طلبها للحصير من أجل استعماله أثناء المناسبات الدينية وخاصة لأداء صلاة العيد.
والأكثر من ذلك، أن هناك تراجع كبير على مستوى الإقبال على شراء منتجات السمار التي طالما كانت في السابق تجد رواجا كبيرا. وقد عزا علي الصديقي هذا التراجع إلى غياب اهتمام واضح من لدن وزارة الصناعة التقليدية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي كانت المروج الرئيسي لتجارة حصائر الدوم، مضيفا على أن اللوم يقع أيضا على وزارة السياحة التي ينبغي عليها أن تقوم بالتعريف بمثل هذه المنتوجات، وذلك حتى يتم ترويجها سياحيا، وبالتالي تشجيع العاملين بهذا القطاع وإعادة إحيائه من جديد، على غرار العديد من الحرف بنفس القطاع.
ويقول علي الصديقي أيضا: “بضاعتنا لم تعد تباع حتى في المناسبات والأعياد الدينية”، مشيرا إلى أنّ العديد المنتجات المصنوعة من السمار مثل الحصير وقع التخلي عليها بسبب التغير بنمط المجتمع وتوجهه للمنتجات الحديثة.
ويصرح “للأسف الشديد لم تعد ربة البيت العصرية تفكر في اقتناء الحصير بعلة أنه لا يتماشى مع المنازل الحديثة، لذلك أصبحنا لا نتعامل إلا مع الحمامات والمساجد التي بقي البعض منها محافظا على الصناعات التقليدية”.
غير أن ما يؤرق، علي الصديقي والمختار، اليوم، هو حيرتهما حول ما سيكون عليه حال المساجد في السنين المقبلة، قائلا “أخاف أن نجد مساجدا بلا حصير وأن يندثر حرفيو صناعة السمار بسبب اعتزال الكثير منهم”.